وائل نجم - كاتب وباحث
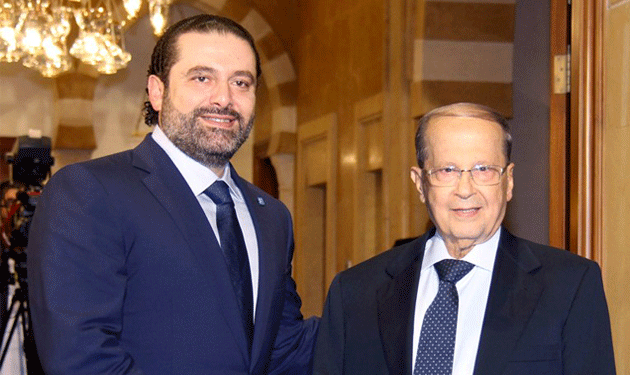
مرّة جديدة أصدر وزير الداخلية، نهاد المشنوق، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفقاً للقانون قبل 21 آذار. مرّة جديدة أيضاً رفض رئيس الجمهورية، ميشال عون، توقيع المرسوم (من ضمن الصلاحيات) وبالتالي عدم اعتبار دعوة الهيئات الناخبة ناجزاً، لأنه يرفض إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون النافذ (قانون الـستين)، لأنه يعتبره قانوناً لا يؤمّن صحة وعدالة التمثيل.
لقد انتهت الفترة القانونية التي تمكّن من إجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة الدستورية للمجلس النيابي، أي قبل 20 حزيران، وفقاً للقانون الحالي، وبالتالي فإن إجراءها بات بحكم المؤجّل لأن أي تعديل للقانون الحالي النافذ قد يحتاج إلى تحضيرات جديدة، هذا إذا اعتبرنا أن الأمور سلكت مسارها الطبيعي بكل انسيابية وبساطة، ومن دون أية تعقيدات. في حين أن الأجواء السياسية والتجاذب القائم على قانون الانتخاب لا يوحيان بذلك.
المسألة إذاً أننا أمام حلّ من اثنين: إما أن يصار إلى الاتفاق على قانون انتخاب جديد خلال الفترة المتبقية حتى عشرين حزيران، وبالتالي الذهاب إلى المجلس النيابي وإقرار هذا القانون الجديد برضا الأطراف السياسية كافة، وبعدها يصار إلى التمديد للمجلس النيابي لفترة زمنية وجيزة حتى تتمكن الاجهزة المعنية في الحكومة من تحضير نفسها لإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد. وهذا بالبطع قد يأخذ بضعة أشهر، ما يعني أننا سنكون أمام ما يسمّونة التمديد التقني. ولا تعارض أية قوة سياسية هذا التمديد، بمن في ذلك رئيس الجمهورية. وإما أن يستمر الخلاف على القانون الانتخابي، ويظل كل طرف يتمسك بطرحه وقانونه الذي يؤمّن له التمثيل الذي يطمح إليه، والهيمنة التي يريدها، وهذا يعني عدم الاتفاق على قانون جديد، ويعني أيضاً أننا قد نصل إلى المهلة الدستورية لولاية المجلس النيابي، أي يوم عشرين حزيران من دون قانون جديد، وقد انتهت ولاية المجلس الحالي، وهنا سنكون أمام معضلة ليست سهلة على الإطلاق. هنا سنكون أمام تفسيرين للدستور والميثاق وروحيتهما.
سيقول التفسير الأول بالفراغ على مستوى السلطة التشريعية، وبالتالي فإن أصحاب هذا التفسير سيرفضون أية شرعية للمجلس النيابي، وهم بالأصل يشكّون في شرعية المجلس الحالي، وفي مقدمة هؤلاء رئيس الجمهورية، ميشال عون، وبنظر هؤلاء فإن المجلس النيابي بعد عشرين حزيران سيكون بحكم غير الموجود.
أما أصحاب التفسير الآخر فيرون أن الحكم استمرارية ولا إمكانية للفراغ على مستوى السلطة التشريعية على اعتبار أنها أم السلطات في النظام الديمقراطي البرلماني الذي يعتمده لبنان، وبالتالي فإن هؤلاء يرون أن انتهاء ولاية المجلس في العشرين من حزيران، من دون التمديد التقني للمجلس الحالي، ومن دون انتخاب مجلس نيابي جديد، يعني استمرار المجلس الحالي بدوره و«واجبه» حتى لا يكون هناك فراغ على مستوى السلطة التشريعية التي تنبثق منها باقي السلطات.
وأمام هذين التفسيرين سنكون أمام معضلة دستورية كبيرة لا يمكن تجاوزها والانتهاء منها بسهولة في ظل السجال الذي سيدور حول دستورية وميثاقية وقانونية أية خطوة يمكن أن تتخذ بعد عشرين حزيران، وهذا بالطبع قد يقود إلى أمر من اثنين: فإما أن يدخل البلد عندها في حوار مفتوح وكبير وواسع لإيجاد صيغة تخرج البلد من الازمة، وهو ما يعبّر عنه البعض بالمؤتمر التأسيسي، والنقاش فيه سيطاول كل شيء، بما في ذلك بنية النظام ومرتكزاته وتفاصيله، خاصة أن البعض سينظر إلى النظام الحالي المستند إلى وثيقة الوفاق الوطني في الطائف (اتفاق الطائف) على أنه قد استنفد أغراضه وانتهى ولا بدّ من نظام سياسي جديد، وهنا نقول إن هذا النظام لن يقوم على أساس العدالة وصحة التمثيل وما سوى ذلك من المفردات، بل سيقوم على أساس الغلبة، أو ستكون فيه الكلمة الفصل لصاحب القدرة على الفرْض والهيمنة، وهنا أقول إن ذلك قد يقود إلى الأمر الثاني، إلا وهو الصدام بين المكوّنات للحفاظ على المكتسبات، لأن كل طرف سيعتبر نفسه مستهدفاً من قبل الآخرين، وبالتالي فإن البلد مع هذه التحوّلات سيكون مفتوحاً على المجهول.
هل يدرك اللبنانيون حجم هذه المقامرة التي يسيرون بالبلد إليها؟ وهل يتدارك المعنيون والمسؤولون الموقف قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة؟! أم أن البعض سيظل يتعاطى مع الأمور على قاعدة «عنزة ولو طارت»؟!